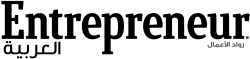إما أن تصدق نفسك فتكون على قدر أحلامك ومستحِقاً لها، أو أن تصدق الأخرين ممن يقولون لك أنك لا تستطيع فينتهي بك العمر ولا تستطيع.
عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، في حلب، في أيام لم يكن يعرف فيها الكثير من العرب التلفزيون، كان حلم مصطفى العقاد أن يصبح نجماً عالمياً لامعاً. سخرت منه حلب، لكنه لم يأبه حمل حلمه وواحدٍ من أحلام العرب، ورحل إلى عالم النجوم في أمريكا، إلى هوليوود. حقق حلمه.. وفي طريقه لتحقيق واحدٍ من أحلام العرب اغتالوه، كما يفعلون دائماً مع أحلامهم.
لو أن ذاكرتنا كاميرا تصور التاريخ كإحدى كاميرات العقاد لاستطعنا الرجوع إلى الماضي وكشفنا حقيقة هذا الأمل الذي كان يعيشه منذ أن كان في ذاك المكان الذي كبر فيه وهو يحلم بالحياة والشهرة والوصول إلى القمة، كان يمشي ويحكي ويطمح وهم جالسون لاهون ضاحكون، وهو مضى في طريقه ليحقق حلمه ويروي لنا حقيقة رسالته التي لطالما حلمنا بها جميعا.
نحلم أحياناً بعوالم جميلة فيها الكثير من الأماني والأمن، والكثير من الحب والسلام. وعندما نصحو نرى في ما يشبه الحلم وعداً وردياً بأن أحلامنا ليست ضرباً من الجنون، ولا هي سعياً للمستحيل. وعداً يصر بأن يقنعنا، بكل الوسائل وكل الأثمان، أننا قادرين، وكبار بإرادتنا وإيماننا. إلا أن حلماً كهذا لا يروق لأشباح الجهل في قلوبنا فتأبى إلا أن ترهبنا فتقتله أمام أعيننا لتقنعننا بصغرنا وبضعفنا، وتنهي القصة قبل أن يكتمل القمر.
لأننا شعب يلتمس درب النجاة لإنقاذ أحلامه، متعلقاً بوميض أملٍ يسعفه، يعيد إليه ماضٍ مجيد، ويمسح الغبار عن هويته الممسوحة الملامح وكرامته الضائعة، لهذه الأسباب كلها، تمنى عجوز التقى مصطفى العقاد في أحد أحياء هذا الوطن الكبير لو يأخذ الله من عمره ويزيد في عمر العقاد ليتحفنا بأفلامٍ على غرار الرسالة و عمر المختار.
تعلق العقاد الذي نتحدث عنه اليوم، بالسينما منذ صغره، حيث كان له جار في حلب، موطنه الأصلي، يصحبه معه ليتعرف على كيفية عرض الأفلام وقص المقاطع الممنوعة منها. ومنذ ذلك الوقت بدأ حلمه ليكون مخرجا سينمائيأ في هوليوود. ولم يكن يرضَ بغير هوليوود، على الرغم من أن أهالي حلب حولوه إلى أضحوكة لأنهم وجدوا في حلمه تحد كبير لإمكانياته المادية المتواضعة آنذاك.
لم يثنه رأي المجتمع المحافظ ولا سخريته اللاذعة عن السعي وراء حلمه وتحقيقه. عمل لمدة عام ليوفر ثمن تذكرة السفر، وكان كل ما قدمه له والده مصحفاً و200 من الدولارات، إلى جانب تربية أصيلة دينية وقومية.
ترك وطنه في بداية الخمسينيات ورحل إلى هوليوود، إلا أنه لم يترك هموم وطنه حتى اللحظة الأخيرة في حياته. وصل إلى عالم جديد ومختلف بكل المعاني في جامعة «يو سي إل آي» ولم يكن الأمر سهلاً فقد كان العقاد غريباً وفقيراً. وفي بداية الأمر لم يكن واثقاً فحتى اسمه العربي «مصطفى» لم يكن مقبولاً في تلك البلاد، إلا أنه رفض تغييره كما يفعل غيره، فعلى حد تعبيره: كيف يغير الاسم الذي أعطاه إياه والده؟ يذكر العقاد أنه حمل معه إحساساً بالنقص، إلا أنه بعد أن تعرف على ذلك المجتمع اكتشف أنه لا ينقصه شيء كونه عربياً مسلماً، وما لبث أن حول إحساسه بالنقص إلى ثقة، ومن تلك النقطة صمم أن ينقل لأمته خلاصة خبرته حول هويته العربية عن طريق مجموعة من الأفلام التي كانت مرحلة فاصلة في نجاحه.
الرسالة
في هوليود رفضت 7 استوديوهات ضخمة وجميع محطات التلفزيون ووكالات الإعلان توظيف مصطفى العقاد. لكنه صمم على المضي قدماً، واستطاع في عام 1976 تقديم فيلمه الشهير «الرسالة» الذي حكى قصة بعث الرسالة النبوية لنبي الإسلام محمد بن عبد الله والهجرة التي قام بها من مكة إلى المدينة و نشأة أول دولة إسلامية.
قال العقاد في مقابلة أجريت معه عام 1976: «لقد عملت هذا الفيلم لأنه كان موضوعاً شخصياً بالنسبة لي، شعرت بواجبي كمسلم عاش في الغرب بأن أقول الحقيقة عن الإسلام. أنه دين لديه 700 مليون تابع في العالم، وهناك القليل مما هو معروف عنه، وقد فاجأني ذلك. لقد رأيت ضرورة أن أحكي القصة التي يمكن أن تغطي هذا النقص الكبير، بالنسبة للجمهور في الغرب.»
وتصديقاً لما اعتقد العقاد وتأكيداً على إنجاز ما أراد من الفيلم، يروي الصحفي العربي أسامة فوزي قصة مع جار أمريكي مقرب جداً إليه. عند وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر جاء هذا الجار إليه وكان متجهم الوجه على غير عادته، وخاطبه قائلاً: «لم أسألك يوماً عن دينك. لكنني اليوم أريد أن أعرف عن ذلك الدين الذي يأمر بقتل الأبرياء بتلك الصورة الوحشية!» كان أسامة فوزي في حيرة من أمره، فكيف له أن يفسر لهذا الجار حقيقة دينه ويفهمه أنه مختلف عن ما يعتقد. وأخيراً لم يجد أمامه أفضل من أن يعطيه نسختين من فيلمي العقاد «الرسالة» و»عمر المختار».
غادر الرجل بالفيلمين وعاد في اليوم التالي مذهولاً مما عرف عن الإسلام وتعاليمه. واليوم يعتبر فيلم الرسالة الذي قام بدور البطولة فيه الممثل العالمي القدير أنتوني كوين، أشهر فيلم إسلامي، ومن أشهر الأفلام الدينية التي أنتجها مخرجون عرب، حيث اعتمد على كفاءات فنية وكتاب من وزن توفيق الحكيم ويوسف إدريس.
ويعرض الفيلم دائماً في المناسبات الإسلامية، وفي التجمعات الطلابية التي ينظم بعضها عروضاً سنويةً للفيديو لهذا الفيلم الممنوع من العرض في كل من سوريا ومصر، بالرغم من موافقة الأزهر على سيناريو الفيلم، وبالرغم من عدم وجود أي اعتراض رقابي عليه. وعرضته المحطات العربية وفي بعض الأحيان بدون إذن من المخرج، وأشار العقاد نفسه إلي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اشترت أكثر من ألف نسخة من هذا الفيلم لعرضها على جنودها الذاهبين إلى أفغانستان.
رعب
بعد «الرسالة» توجه العقاد إلى إنتاج سلسلة أفلام الرعب «هالوين» التي تعد من أشهر أفلام الرعب النفسي والفنتازيا في هوليوود حتى يومنا هذا. أنتج من «هالوين» 8 أجزاء وأضاف فيلم رعب أخر هو «موعد مع الخوف» وأخر كوميدي وهو «توصيلة مجانية». وحول سبب توجهه لإنتاج أفلام الرعب يقول العقاد أنها كانت الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تمكنه كسب قوته دون تقديم أي تنازلات سياسية أو أخلاقية.
زادت هذه السلسلة من شهرته كما كونت له ثروة لا بأس بها، وأغنته كما قال، عن تقديم أي تنازلات كانت بالنسبة له أمور لا يقبل التفاوض عليها. ومكنته من حرفته ولغته وأدواته السينمائية، وجعلت معظم استوديوهات الإنتاج السينمائي تتسابق للتعاون معه، بما في ذلك «يونيفرسال» التي تعاونت معه علي إنتاج أفلام هالوين. ولكن فخر العقاد ظل بالنسبة إليه في أفلامه مثل عمر المختار الثائر والمجاهد الليبي الذي قاتل الإيطاليين وأعدم دفاعاً عن أرضه ووطنه وعقيدته.
عمر المختار
في عام 1989 قدم العقاد لجمهور العربي فيلم «أسد الصحراء» ويروي فيه قصة عمر المختار، وأظهر فيه فظاعة الجرائم الفاشية في ليبيا، عندما أقدم الجنرال الإيطالي «رودولفو غراتسياني» على قتل 200 ألف مواطن في محاولته اليائسة لتنفيذ خطة الاستيطان في ليبيا. وأظهر فيه بالمقابل بسالة ونبل عمر المختار في الدفاع عن وطنه وتنغيص عيش الإيطاليين في بلاده. وفي تعليق للعقاد حول انتقاد على الفيلم يقول بأن الذي قتل عمر المختار كان زنجياً وليس إيطالياً كما صوره الفيلم، يقول العقاد: «ليس المهم من قتل المختار وإنما المهم هو أن التاريخ لن يرحم الفاشيين الذين استباحوا دماء الشعب الليبي».
بقايا أحلام..
انتظر العقاد طويلاً لسنوات طويلة قبل أن ينتج فيلما سينمائيا مماثلا لفيلمي «الرسالة» و»عمر المختار»، وكان «صلاح الدين الأيوبي» هو العمل الذي اختاره ونذر نفسه في سبيل إعداده، ولكنه رحل عنا محتفظاً بسيناريو ورؤية إخراجية للفيلم الذي طال انتظاره بسبب عدم توفر الدعم المالي المطلوب. كان العقاد مصراً على هذا الفيلم بالذات، فكان يحمل فكرته أينما رحل أو حل، لأنه رأى أن هذا هو الوقت المناسب له، على اعتبار أن سيرة صلاح الدين هي الإسقاط المعاصر للأحداث التي تجري على الساحة العربية اليوم. كما أنه أراد أن يقول من خلاله أن القدس عربية وأنها ستعود إلينا مهما طال زمن الاحتلال وطغى.
وبما أن الفكرة انبثقت من هذا المنطلق فإنها كالعادة تعرضت لمساومات كثيرة في معظم أقطار الوطن العربي بفعل الإسقاطات المعاصرة التي كانت تحملها؛ ونظراً لتشابه الظرف الموضوعي في العالم العربي فهو ذاته الظرف الذي خرج فيه صلاح الدين، وبذلك كان حاله كبقية أحلامه السابقة واللاحقة التي كانت تصطدم بالحكومات العربية التي تطلب أفلاماً تمجدها. فقد كان يرى أن رمز صلاح الدين مناسباً لوضعنا الحالي، وكان يريد إخراج فيلم لتثبيت عروبة فلسطين والتأكيد انه مهما طال الزمن ومهما ساءت الظروف، كما حدث أيام الحروب الصليبية، حيث سيطر الغرب على المنطقة قرابة مائتي عام، فإننا يجب ألا نيأس.
رحل العقاد وهو يبحث عن تمويل لهذا المشروع الكبير، وقد انصب انشغاله على هذا الفيلم بالذات لأنه رأى أن تقديمه الآن وفي الظرف الحالي يعمل على الموازنة بين فظائع الصليبيين، وحروب بوش ضد الإرهاب، وكان يبحث عن ممول له منذ عشرين عاماً.
وفي أحاديثه الكثيرة أعطى العقاد انطباعا بأن نص الفيلم جاهز، وأنه من إعداد كاتب أمريكي، بل وفكر في الممثلين مثل البريطاني شون كونري بطل أفلام جيمس بوند ولكن المشكلة ظلت في الممول، الذي حكي أنه ربما كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين،. إلا أن ذلك لم يحدث، وظل العقاد رغم إحباط العرب لكل محاولاته، وحتى اللحظة الأخيرة يحلم بأن يقول للعالم كله أننا كمسلمين وكعرب نبلاء ونحمل رسالة.
إضافة لحلمه الكبير صلاح الدين، الذي عاش معه 20 عاماً ولم يتحقق، كان العقاد يطمح أن ينتج فيلماً عن «صبيحة الأندلسية» وهي المرأة التي حكمت الأندلس، وفيلماً آخر يروي قصة ملك من ملوك إنجلترا كان قد أرسل في عام 1213م وفداً إلى الخليفة في الأندلس يطلب منه أن تكون إنجلترا تحت حماية الخليفة المسلم. وتلك مفارقة أراد المخرج القدير أن يصنع إسقاطاً تاريخياً عبر تعامله معها أمام قلة حيلة أنظمتنا العربية، وانعكاس الحالة كلياً في أيامنا هذه.
ظل العقاد دائماً يحلم ويفكر، فمع كل مأساة تصيب العالم العربي والإسلامي كان يفكر بمشاريع. وعندما اندلعت حرب البوسنة فكر في إنتاج فيلم بعنوان «وامعتصماه»، وعند تدمير الجيش الروسي مدينة غروزني فكر بإنتاج فيلم عن الإمام محمد شامل، الثائر والمجاهد الشيشاني المعروف. وقبل وفاته تحدث العقاد عن فكرة إخراج فيلم عن أسامة بن لادن، وقال أن هناك اختلافاً في تعريف من يكون بن لادن.
لم تنحصر أحلامه في الأفلام بل كان يحمل رؤية مستقبلية أوسع من فكرة إنتاج عمل أو مجموعة أعمال؛ فأحلامه تضمنت إقامة مدينة سينمائية أو مجمع سينمائي للإنتاج بمستوى الإنتاج العالمي، بروح عربية إسلامية وبمستويات الرسالة التي تحملها أمته، وكان تصوره عن هذه المدينة أنها مدينة لا تبنى، بل استوديوهات قابلة للتنقل، فقد كان عازماً على نقل التجربة الأمريكية مثل «يونيفيرسل استوديو» في هوليوود (أي نموذج الاستوديوهات المتحركة(.
كان غياب العقاد تراجيدياً فقد رحل عن العالم في تفجيرات طالت الفندق الذي كان ينزل فيه في إحدى زياراته لمدينة عمان. وغاب الصوت الذي كان يريد تقديم التفسير ربما حول ما كان سببا في موته.
كم من الأعوام سيمر حتى يأتي عربي مناضل ومجتهد أخر قادر على الوصول إلى العالمية ومتمكن من مهنته بحرفية عالية، يجيد مخاطبة الغرب بلغتهم، ويسافر إليهم دون أن يترك أي جزء من هموم وطنه إلا ويحملها في قلبه.
غريب أن تعجز أمة ينتمي إليها مليار شخص عن تمويل فيلم، بينما لا تعجز عن تمويل قنوات فضائية لا حصر لها، وغريب أن يحمل همها في قلبه كل تلك السنين وتغتاله، ثم تنعيه بشكل مختصر لتطوي صفحةً مليئةً بأحلام غير مرغوب بها.